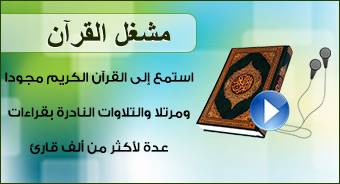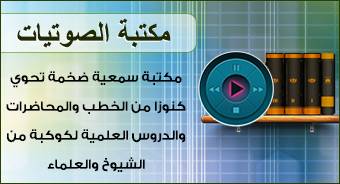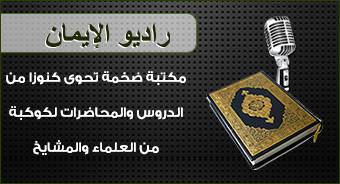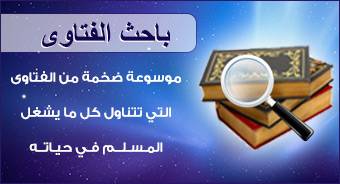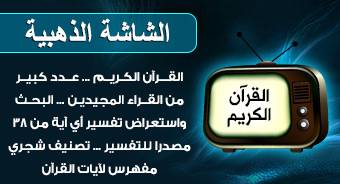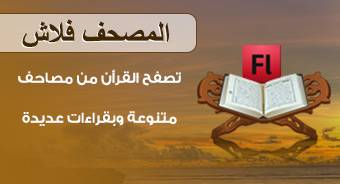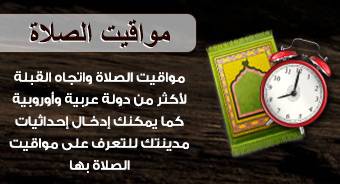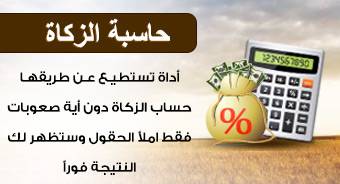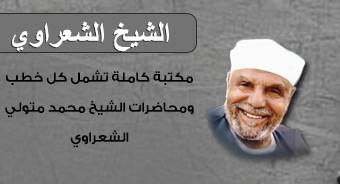|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
قال ابن عطية: وكلام سيبويه متجه على النظر النحوي، وإن كان الطول قبل حرف العطف أتَمَّ، فإنه بعد حرف العطف مؤثر، لاسيما في هذه الآية، لأن «لا» ربطت المعنى؛ إذ قد تقدمها نفي، ونفت هي أيضًا عن «الآباء» فيمكن العطف.واختار أبو عبيد قراءة رفع الجميع، وهي رواية الكسائي؛ لأن أنَسًا رضي الله عنه رواها قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم.وروى أنس عنه- عليه الصلاة والسلام- أيضًا «أن النَّفسُ بالنَّفسِ» بتخفيف «أنْ» ورفع «النفس»، وفيها تأويلان:أحدهما: أن تكون «أنْ» مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير الأمر والشأن محذوف، و{النفس بالنفس} مبتدأ وخبر، في محل رفع خبرًا لـ «أن» المخففة، كقوله: {أَنِ الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} [يونس: 10] فيكون المعنى كمعنى المشدّدة.والثاني: أنها «أنْ» المفسرة؛ لأنها بعد مَا هو بمعنى القول لا حروفه وهو {كتبنا}، والتقدير: أي النفسُ بالنفس، ورُجِّح هذا على الأول بأنه يلزم من الأول وقوع المخففة بعد غير العلم، وهو قليل أو ممنوع، وقد يقال: إن {كتبنا} لمّا كان بمعنى «قضينا» قَرُبَ من أفعال اليَقينِ.وأما قراءة نافع ومن معه فالنَّصْبُ على اسم «أنَّ» لفظًا، وهي النفس، والجار بعده خبرُه.و{قصاصٌ} خبر {الجروح}، أي: وأن الجروح قصاص، وهذا من عطف الجُمَلِ، عطفت الاسم على الاسم، والخبر على الخبر، كقولك «إنَّ زيدًا قائمٌ وعمرًا منطلق» عطفت «عمرًا» على «زيدًا»، و«منطلق» على «قائم»، ويكون الكَتْبُ شاملًا للجميع، إلاَّ أنَّ في كلام ابن عطية ما يقتضي أن يكون {قصاص} خبرًا على المنصوبات أجمع، فإنه قال: وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب ذلك كلِّه، و{قصاص} خبرُ «أنَّ»، وهذا وإن كان يصدقُ أن أخْذَ النفس بالنفسِ والعين بالعينِ قصاص، إلا أنه صار هنا بقرينة المقابلة مختصًا بالجروح، وهو محل نظر.وأما قراءة أبي عمرو ومن معه، فالمنصوب كما تقدم في قراءة نافع، لكنهم لم ينصبوا {الجروح} قطعًا له عما قبله، وفيه أربعة أوجه: الثلاثة المذكورة في توجيه قراءة الكسائي، وقد تقدم إيضاحه.والرابع: أنه مبتدأ وخبره {قصاص}، يعني: أنه ابتداء تشريعٍ، وتعريف حكم جديد.قال أبو علي: فأمّا {والجروح قصاص} فمن رفعه يقْطَعُهُ عما قبله، فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في قراءة من رفع {والعين بالعين}، ويجوز أن يستأنف {والجروح قصاص} ليس على أنه مما كُتب عليهم في التوراة، ولكنه على الاستئناف، وابتداء تشريع. انتهى.إلا أن أبا شامة قال- قبل أن يحكي عن الفارسي هذا الكلام-: «ولا يستقيم في رفع الجروح الوجه الثالث، وهو أنه عطف على الضمير الذي في خبر «النفس» وإن جاز فيما قبلها، وسَبَبُهُ استقامة المعنى في قولك: مأخوذة هي بالنفس، والعين هي مأخوذة بالعين، ولا يستقيم، والجروحُ مأخوذة قصاص، وهذا معنى قولي: لما خلا قوله: {الجروح قصاص} عن «الباء» في الخبر خالفَ الأسماءَ التي قبلها، فخولف بينهما في الإعراب».قال شهاب الدين: وهذا الذي قاله واضح، ولم يتنبه له كثير من المُعرِبين.وقال بعضهم: «إنما رُفِعَ {الجروح} ولم يُنْصَبْ تَبَعًا لما قبله فَرْقًا بين المجمل والمفسر».يعني أن قوله: {النَّفْسَ بالنفسِ والعينَ بالعينِ} مفسّر غير مجمل، بخلاف {الجروح}، فإنها مجملة؛ إذ ليس كل جرح يجري فيه قصاصٌ؛ بل ما كان يعرف فيه المساواة، وأمكن ذلك فيه، على تفصيل معروف في كتب الفقه.وقال بعضهم: خُولِفَ في الإعراب لاختلاف الجراحات وتفاوتها، فإذن الاختلاف في ذلك كالخِلافِ المُشَارِ إليه، وهذان الوجهان لا معنى لهما، ولا ملازمة بين مُخَالَفَةِ الإعراب، ومخالفةِ الأحكام المُشَارِ إليها بوجهٍ من الوُجُوهِ، وإنما ذكرتها تنبيهًا على ضعفها.وقرأ نافع: {والأذْن بالأذْن} سواء كان مفردًا أم مثنى، كقوله: {كَأَنَّ في أُذُنَيْهِ وَقْرًا} [لقمان: 7] بسكون الذال، وهو تخفيف للمضموم كـ «عُنْق» في «عُنُق» والباقون بضمهما، وهو الأصل، ولابد من حذف مضاف في قوله: {والجروحُ قصاص}: إمَّا من الأول، وإمَّا من الثاني، وسواء قُرئ برفعه أو بنصبه، تقديره: وحكم الجروح قصاص، أو: والجروح ذات قصاص.والقِصَاصُ: المقُاصَّةُ، وقد تقدم الكلام عليه في «البقرة» [الآية 178].وقرأ أبيّ بنصب {النفس}، والأربعة بعدها و{أن الجُرُوحُ} بزيادة «أن» الخفيفة، ورفع «الجُرُوح»، وعلى هذه القراءة يَتعيَّنُ أن تكون المخففة، ولا يجوز أن تكون المفسرة، بخلاف ما تقدَّم من قراءة أنس عنه عليه السلام بتخفيف «أن» ورفع «النفس» حيث جوزنا فيها الوجهين، وذلك لأنه لو قدرتها التفسيرية وجعلتها معطوفة على ما قبلها فسد من حيث إن {كتبنا} يقتضي أن يكون عاملًا لأجل أنّ «أن» المشدّدة غير عامل لأجل «أنْ» التفسيرية.فإذا انتفى تسلّطه عليها انتفى تشريكها مع ما قبلها؛ لأنه إذا لم يكن عمل فلا تشريك، فإذا جعلتها المُخَفَّفَةَ تسلَّطَ عمله عليها، فاقتضى العمل التشريك في انصباب معنى الكَتْبِ عليهما.وقرأ أبيّ: {فهو كفارته له}، أي: التصدق كفارة، يعني الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها وهو تعظيم لما فعل كقوله: {فَأَجْرُهُ عَلَى الله} [الشورى: 40].قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ} أي: بالقصاص المتعلق بالنفس، أو بالعين أو بما بعدها، فهو أي: فذلك التصدقُ، عاد الضمير على المصدر لدلالة فعله عليه، وهو كقوله تعالى: {اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة: 8].والضمير في {له} فيه ثلاثة أوجه:أحدها: وهو الظاهر: أنه يعود على الجاني، والمراد به وَلِيّ القصاص أي: فالتصدق كَفَّارة لذلك المتصدق بحقه، وإلى هذا ذهب كثير من الصحابة فمن بعدهم ويؤيده قوله تعالى في آية القصاص في البقرة: {وأن تعفوا أقرب للتقوى}.والثاني: أن الضمير يراد به الجاني، والمراد بالمتصدق كما تقدم مستحق القصاص، والمعنى أنه إذا تصدق المستحق على الجاني، كان ذلك التصدق كفارة للجاني حيث لم يُؤاخذ به.قال الزمخشري: «وقيل: فهو كفارة له أي: للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه في الدنيا والآخرة» فأمّا أجر العافي فعلى الله قال الله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله} [الشورى: 40] وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَصدَّقَ مِنْ جسدِهِ بِشَيءٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِقدرِهِ مِنْ ذُنُوبِهِ» وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما في آخرين.الثالث: أن الضمير يعود على المتصدق أيضًا، لكن المراد الجاني نفسه، ومعنى كونه متصدقًا، أنه إذا جنى جناية، ولم يعرف به أحد، فعرف هو بنفسه، كان ذلك الاعتراف بمنزلة التصدق الماحي لذنبه وجنايته قال مجاهد.وَيُحْكَى عن عروة بن الزبير أنه أصاب إنسانًا في طوافه، فلم يعرف الرجل من أصابه، فقال له عروة: «أنا أصبتك، وأنا عروة بن الزُّبَيْرِ، فإن كان يعنيك شيء فَهَا أنَا ذَا» وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون «تصدَّق» من الصدقة، وأن يكون من الصِّدْق.قال شهاب الدين: فالأول واضح، والثاني معناه أن يتكلف الصدق؛ لأن ذلك مما يشق.وقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم} يجوز في «مَنْ» أن تكون شرطية، وهو الظاهر، وأن تكون موصولةً، والفاء في الخبر زائدة لشبهه بالشرط.و{هم} في قوله: {هم الكافرون} ونظائره فصل أو مبتدأ، وكله ظاهر مما تقدَّم في نظائره. اهـ. باختصار.
|